‹‹لماذا تقرأ القصص والروايات؟››
السؤال الأزلي الأبدي الذي يتلقاه كلُّ قارئ، فضلاً عن الكاتب الذي هو المسبب الأول لهذه الرذيلة المنتشرة في المجتمعات التي تدَّعي الثقافة.. يرى السائلُ أن الروايات والقصص مجرد خيال لا فائدة منه، مضيعة للمال، مضيعة للوقت.. تغييب؛ الكاتب يرسم الوهم، والقارئ يُغيَّب فيه.
لو صدق السائل فنحن في مشكلة كبيرة؛ القصص تغييب، الأفلام تغييب، الفنون والرسوم تغييب، وبرامج تصميم الصور مثل الفوتوشوب تغييب.. الإبداع الذي نُصفِّق له سيسقط كثيرٌ من أشكاله في بئر التغييب هذا، حتى الطُّرَف والنُّكت تغييب، إذ نحن نضحك على شيء خارجٍ عن حدود الواقع، مجرد حكاية مُختلقة تُخرجنا عن عالمنا، بكل ما فيه من تراجيديا، فنضحك غائبين عن حياتنا التي نحياها.
فإذا تعمقنا في الأمر أكثر لتساءلنا: لماذا نحلم؟ الله سبحانه وتعالى خلق لنا الواقع، ثم حينما ننام يُرسلنا إلى عالم آخر مليء بالخيال، هل الأحلام مضيعة للوقت أيضاً؟ تغييب؟!
الروائي المصري خيري شلبي له رأي في الخيال، يقول: ‹‹الخيال لا يعني تأليف شيء من العدم، أو تخيُّل عالم بأكمله من الفراغ، إنما الخيال هو عمق الإحساس بالتجربة المعيشة، سواءً عاشها المرء بنفسه، أو عايشها عن كثب››.. معنى كلامه أن الخيال ليس وهماً، إنما هو إسقاط على الواقع بطريقة حسيَّة.
ليس وهماً؟ أليس الخيال هو الوهم؟ ما الفرق بينهما إذن؟
بعض الصقور وهي تطير عالياً تلمح ظِلَّها على الأرض، فيُهيًّأ لها أنها فريسة تركض، تنقضُّ عليه ثم تكتشف سذاجتها.. هكذا يمكننا التفرقة بين الخيال والوهم فنصف الخيال أنه ظِلُّ الصقر، وما تبادر إلى ذهنه هو الوهم.
الوهم يظهر جليًّا في المدمن يبحث عن السعادة في ما يتعاطاه.. الوهم في الجنس الكتابي الذي يمارسه البعض عبر الرسائل الإلكترونية، يحاولون تفريغ طاقات مُهدرة.. الوهم فيما يزرعه الإرهابيون في عقول شبابنا أنَّ الجنة تكمن وراء عملية انتحارية، ثم مصيرك الخلود والحور العين وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. الوهم مرضٌ.
في فيلم ‹آسف على الإزعاج›، يرى أحمد حلمي والده، يجالسه ويحادثه ويستمع إلى نصائحه التي لا تنتهي، كل هذا ليس حقيقيًّا، فأبوه ميت، هذا هو الوهم، مرض يسيِّر حياتك إلى خراب.. سمبا الأسد أيضاً يرى أباه الميت، يجالسه ويحادثه ويستمع إلى نصائحه التي لا تنتهي، لكن هنا لا نقول إن أباه وهم، بل هو خيال، وليس الخيال مرضاً، بل لقد اكتسب سمبا قوته من هذه اللقاءات بينه وبين والده.. حينما تصنعك اللا حقيقة عندها هذا وهم، وحينما تصنع أنت هذه اللا حقيقة يكون خيالاً.. الخيال حالة صحية، يعرف المتخيِّل أنه ليس حقيقيًّا، على خلاف المتوهم لا يدرك أن هذا الأمر ليس واقعاً.. إن كلمة (اتهام) جاءت من الوهم؛ لذلك المتهم في القانون بريء حتى تثبت إدانته.
نعود إلى سؤالنا الأول: لماذا نقرأ القصص والروايات؟
هذه الأعمال الأدبية ليست وهماً، لو كانت وهماً فهي تغييب بالفعل، لكنها خيال، والخيال غدة إيجابية في روح الإنسان، لو كانت للأرواح غدد فالخيال أهم غددها.. الواقع وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى ما هو أعمق من الواقع كي نحيا بما يليق بنورانية أرواحنا، يصف الشاعر فاروق جويدة هذا الأمر فيقول: ‹‹إن الخيال هو الحلم بشيء أفضل من الواقع، والذين لا يفكرون في غير واقعهم لا يرون شيئاً غير أقدامهم، وعادةً ما يسقطون››.. لهذا خُلق لنا الخيال، لهذا خُلقت لنا الأحلام، كم هو بائس أن نعيش الواقع فقط، مع قسوة النهار الطويل نحتاج إلى ليل هادئ يربِّت بيده على أرواحنا، هكذا كانت رحمة الله بأبطال معركة بدر أن جعلهم يحتلمون قبل المعركة، الاحتلام لم يكن وهماً، كان خيالاً زرع في قلوبهم الثبات والطمأنينة والهدوء.. اقرأ قصة خيالية، ثم انهض وواجه معركة واقعك بثبات، وثقة، وبحرٍ هادئ من الطمأنينة.
الحبيب الذي يتخيَّل وجه حبيبته الغائبة على وجه القمر كلما اشتاق إليها، أو على سطح قهوته كلما ارتشف منها رشفة، الطفل الذي يتخيَّل أنه بطل يصرع أعداءه، قوي يهزم الأشرار، القارئ الذي يقرأ قصة ويرى نفسه في شخصية القصة بعبقريته أو بفكاهته أو بجاذبيته أو بجرأته.. كل هذا خيال، لكنه خيال إيجابي يقود إلى شكل من أشكال السعادة التي يبحث عنها كلٌّ بحسب طبيعته.
هذا هو الخيال، لماذا خُلق الوهم إذن؟
قديماً كانت العرب إذا جاعت وبكى أطفالهم من الجوع، يضعون في القدور حجارة ويشعلون تحتها النار، يوهمون أطفالهم أنهم يطبخون، يهدأ الأطفال فينامون.. الوهم الذي نصنعه في عقول الآخرين هو الوهم الإيجابي، أما الوهم الذي نزرعه نحن بأنفسنا في عقولنا فهو السلبي المرفوض، تماماً كقصة سجين لويس الرابع عشر.
زار الإمبراطورُ أحدَ سجنائه المحكوم عليهم بالإعدام، أعطاه فرصة للنجاة من الموت إذا هو استطاع الخروج من الزنزانة قبل شروق الشمس؛ هناك مخرج وحيد عليك العثور عليه.. وطوال الليل لم ينم السجين، بحث في كل أرجاء الزنزانة عن هذا المخرج، تحسس كل طوبة في الجدار وفحص كل زاوية، لكنه لم يعثر على شيء ألبتة، إلى أن جاء الصباح.. عند شروق الشمس جاءه الإمبراطور ليخبره أن باب الزنزانة كان مفتوحاً طيلة الليل، كل هذا والسجين يتوهم أن الباب مغلق.. هذا هو الوهم السلبي الذي صنعه السجين بنفسه في نفسه.
نعود من جديد إلى الوهم الإيجابي.
إيميل كوي صيدلاني فرنسي، جاءه مريض يتألم، ولم يكن لدى الصيدلاني علاج لآلامه، فاعتذر، لكن المريض ألحَّ على الصيدلاني أن يتصرَّف، فالآلام لا تُحتمل، هكذا اضطرَّ كوي إلى خداع المريض كي يتخلَّص منه، أمره أن يحضر بعد ثلاث ساعات ريثما يجهِّز له الدواء.
خرج المريض من الصيدلية، في حين عمد الصيدلاني إلى مختبره، جهَّز أقراصاً من السُّكر موَّهها كي تبدو على هيئة دواء، لما حضر المريض استلم دواءه ورحل.. بعد فترة ساعات عاد المريض يشكره وقد شُفي تماماً من آلامه.
إيميل كوي هذا هو أول من استخدم دواء بلاسيبو Placebo ما عُرف لاحقاً بالعلاج الوهمي، يعتمد على خداع الطبيب لمرضاه بمواد غير ضارة، توهم المريض أنه علاج ودواء مفيد لمرضه، ومن جراء هذا الوهم يتعالج نفسيًّا، وأكثر استخدامه لمرضى الاكتئاب، والقولون، والشلل الارتعاشي الباركنسون، وغالباً ما ينجح هذا العلاج لدى كثير من المرضى.
هناك هذا المقطع في كتاب ‹الأحلام› للكاتب مصطفى محمود، يقول فيه: ‹‹مشكلته أنه لا ينام، يقضي ليالياً بطولها مؤرقاً لا يذوق النوم، يصرخ أن أعطيه أقراصاً منومة، ومن عاداتي أن أعطيه أقراصاً من النشا، أقول له إنها أقراص شديدة المفعول، وهى نفس الطريقة التي يستخدمونها في العيادات النفسية.. ويبتلع الأقراص المزيفة، وبعد دقائق تثقل أجفانه، وبعد دقائق أخرى يزحف النوم إلى عينيه، ويغط في سبات عميق، ليس بمفعول الأقراص، ولكن بمفعول الوهم.. إنَّ مرضه وهم، ودواؤه وهم، وهو نفسه وهم، وكلنا أوهام، أوهام تعسة كبيرة››.. الدكتور مصطفى يفسر لنا، في مقطعه هذا، دواء بلاسيبو في أوضح أشكاله.
لكن هل العلاج الوهمي هذا يتماشى مع أخلاقيات الطبيب؟
الجواب معقَّد بعض الشيء.. بلاسيبو كما هو واضح علاج غير أخلاقي، يعتمد على الخداع والكذب أمام مريض ائتمنه، ومن جهة أخرى عدم اللجوء إليه لا أخلاقي كذلك، إذ من حقه أن يسيء إلى صحة المريض.. هكذا اختلف الأطباء في تصنيف أخلاقيته، والبعض أرجعه إلى أمانة الطبيب وصدقه، وإيمانه بفعالية دوائه.
هناك ما هو عكس بلاسيبو هذا، يُطلق عليه اسم نوسيبو Nocebo أو ما عُرف بالوهم المرضي، وهو أن يتناول المريض طعاماً عاديًّا، أو حتى دواءً نافعاً، لكنه يتوهم أن هذا الطعام أو هذا الدواء سوف يُمرضه، فيمرض بالفعل.
إن لعبة الوهم مستمرة، ما بين إيجابياته وسلبياته، كما تلاحظون.
روَّاد البرمجة اللغوية العصبية ومحاضرو التنمية البشرية يتاجرون، في كثيرٍ من الأحيان، بالوهم كذلك، مثل أن ينصحون الضعيف كي يردد: ‹‹أنا قوي››، والفقير كي يردد: ‹‹أنا غني››، والفاشل يردد: ‹‹أنا ناجح››، وهكذا، متجاهلين بهذا فلسفة (اعرف نفسك) التي نادى بها سقراط، هذه الكلمات الوهمية لن تغير من حياة الضعيف ولا الفقير ولا الناجح، بل على الضعيف أن يقوِّي نفسه، والفقير أن يعمل ليكسب الرزق، والفاشل أن يبحث عن مجال آخر يتقنه بدلاً من التخبط في الأمر الذي لا يبدو أنه من اختصاصه.. على القط أن يعرف أنه قط، لا معنى لإيهامه أنه أسد، هذا يجعله يتجوَّل في الغابة ملكاً وهميًّا، سيتعرض للسخرية من بقية الحيوانات، وربما للعقاب كذلك من الضواري.
التحفيز لا يأتي بالوهم، التحفيز يتطلب أن نعرف حقيقتنا وقدراتنا، وأن ندرك أين نحن مما نحن فيه.
خُلاصة حياتنا فوق أثافي الواقع والخيال والوهم هي أنَّ الحياة الحقيقية تقتضي خروجنا من واقعنا قليلاً بالخيالِ كنوعٍ من الترفيه، لكن لا نبتعد عنه كليَّةً فيصيبنا الوهم والوهن.
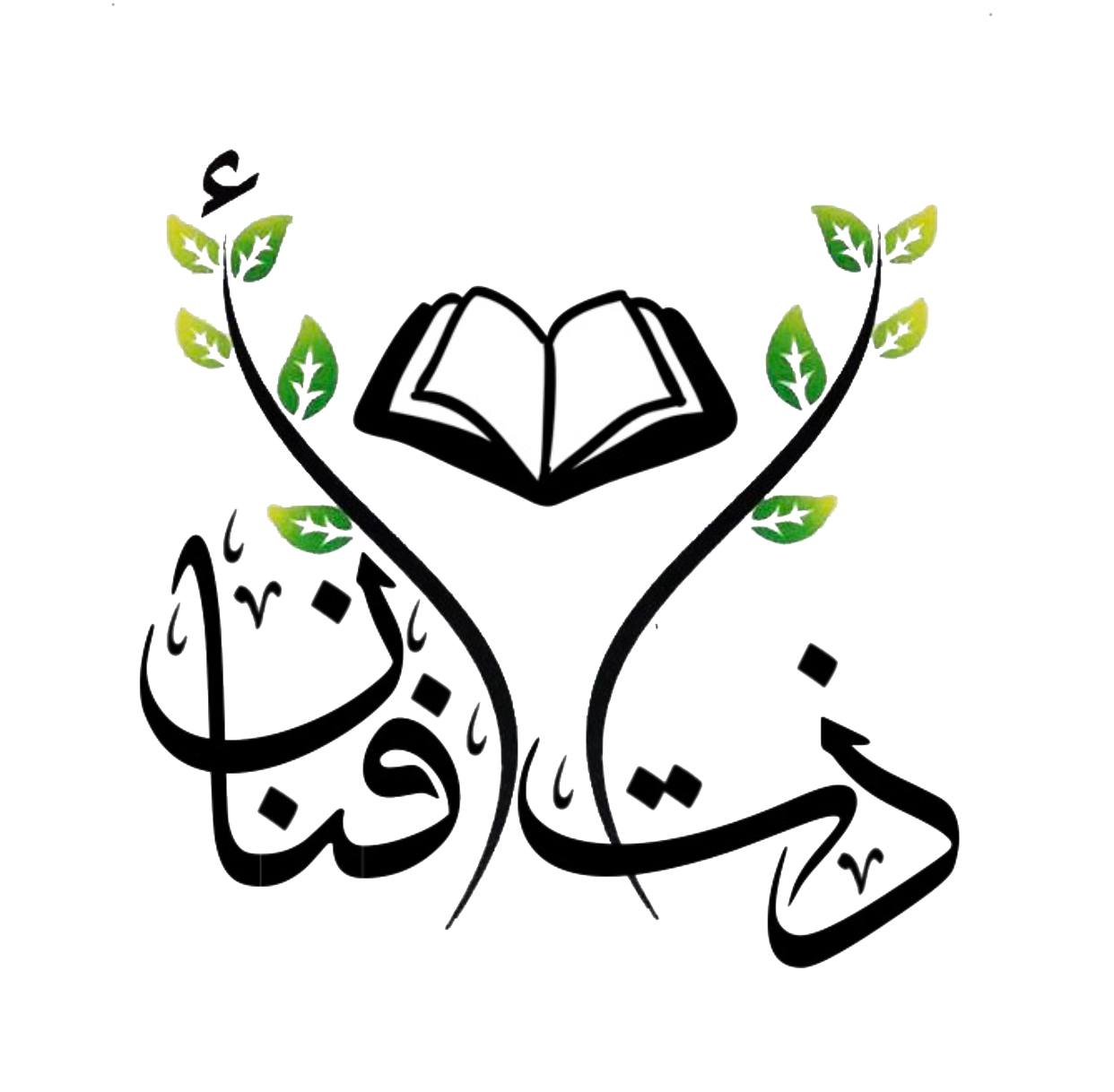



























التعليقات ()