هذه المراجعة نتاج قراءة جماعية لمجموعة
«مائدة الكتب»
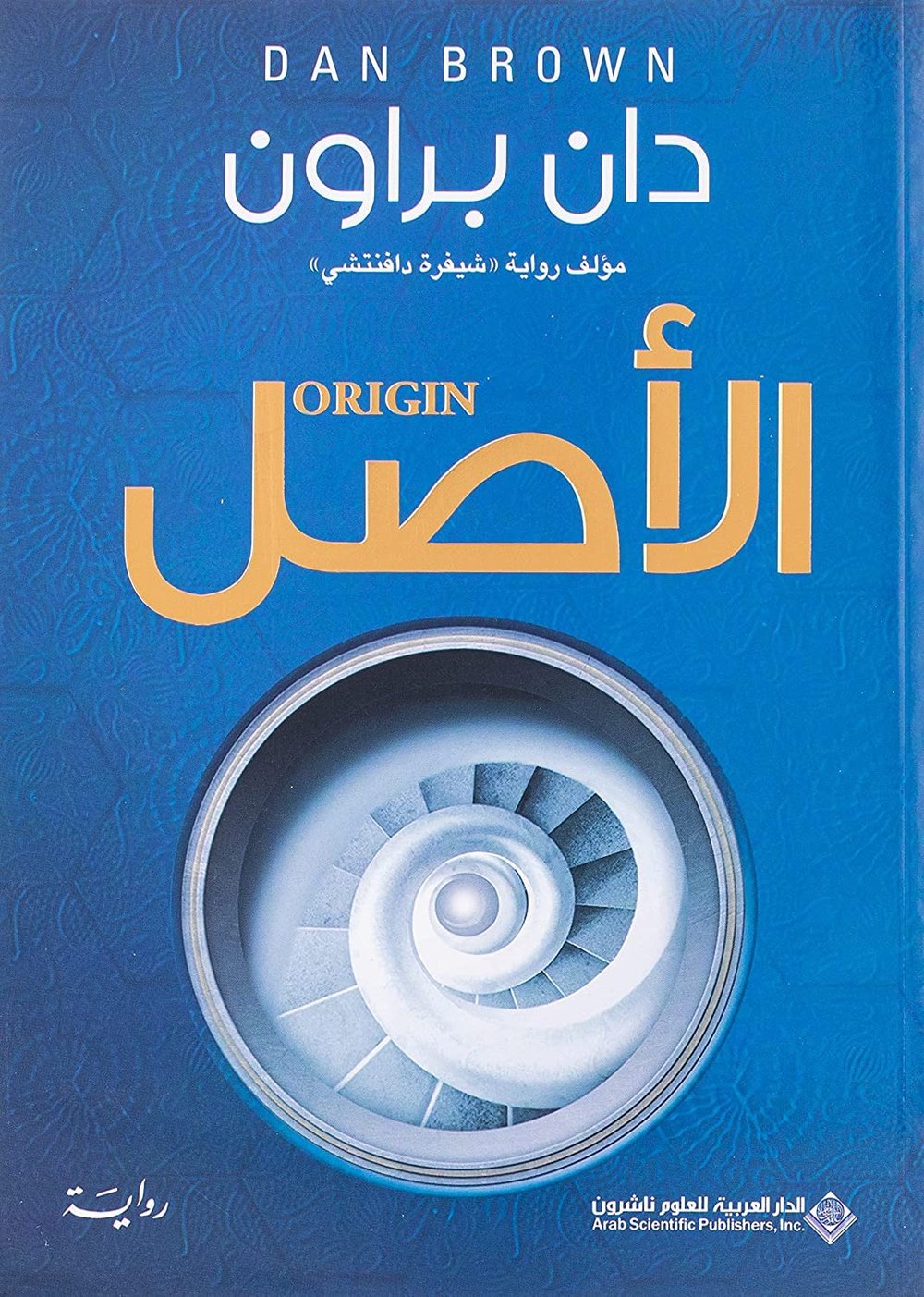
يستمر دان براون الإبحار بنا في رحلة التشويق من خلال بطله الدائم للسلسله؛ البروفيسور (لانجدون)، أستاذ الرموز بجامعة هارفارد، وهذه المرة من خلال حل لغز جريمةٍ تقع في حفل أقيم في متحف الفن الحديث بمدينة بلباو الإسبانية، وخلال رحلة البروفيسور في حل اللغز نتابع بتشويق تجربة ماتعة يأخذنا فيها براون إلي إسبانيا، بتاريخها ومعالمها وأروقة كنائسها وقصورها ومتاحفها .
نتعرض كقراء لكمٍّ هائلٍ من المعلومات، والأمكنة والصروح، ووصفٍ دقيقٍ وماتعٍ ومغذٍّ لخيالنا القاريء.
يطرح براون في هي هذه الرواية سؤالين طالما حيرا البشرية منذ نشأتها، وهما؛ من أين أتينا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
وخلال الأحداث، يحاول عرض وجهات نظر مختلفة للإجابة عن السؤالين، كالأديان والفلسفة والعلم.
وقد وضع الكاتب شخصية العالم الشاب أدموند كيرش رمزا للعلم والمادة والاتجاه المعاصر للانفتاح على العلم والإيمان المطلق بالمادة، فهو عالم تكنولوجيا وحوسبة فذ، وهو ملحد أيضا لا يومن بالأديان، متعصب للعلم ولا شيء غيره، ولا يؤمن إلا بما يمكن إثباته ماديا.
في افتتاحية الأحداث يقابل كيرش مندوبين من الديانات الإبراهيمية الثلاثة (المسيحية، واليهودية، والإسلام) على هامش مؤتمر أديان العالم، ليعرض عليهم اكتشافه الذي يدّعي أنه سيغير مجرى البشرية، ووضعَ الأديان، ومستقبلها، هذا الاكتشاف الذي يجيب فيه عن السؤالين؛ من أين أتينا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ أو بالأحرى (قصة الأصل).
يدّعي كيرش أنه سيغير العالم، ووجهة نظر الناس اتجاه معتقداتٍ قديمةٍ لا تقدم تفسيراً مقنعاً وشاملاً عن تساؤلات البشرية، ويوجههم نحو ما يجب أن يؤمنوا به، وهو العلم القادر على الإجابة عن تلك التساؤلات، وقد حدد موعداً للكشف عن اكتشافه من خلال حفل يُدعى له كبار الشخصيات إلى متحف الفن الحديث، ويُبث على الهواء مباشرة، وهو مسرح الجريمة في الاحداث.
وهنا عزيزي القاريء، لا بد لك وأنت تشرع في قراءة هذه الرواية، أن تنحِّي تعصبك لمعتقدك الديني قليلا، فأنت على موعد مع كاتب سيقلب لك مزاجك كما تقلب صفحات الرواية، فتارة ينتصر لإيمانك وتارة ينتصر للعلم والمادة، وهذا ما أعتبره عبقريا في طريقة براون، فهو يخلق تلك الحاله من تناقض وتبعثر الأفكار المطروحة ليترك على عاتقك الاستنتاج.
والرواية لا تتركنا نستنتج ونتسأءل فحسب، بل نحن أمام تجربة لرحلة بحث ذاتية عن معلومات تاريخية، ومعالم وقراءة عن نظريات علمية، فلم أترك مكاناً وصفه الكاتب إلا واستخدمت محرك البحث لأرى هذا المكان من خلال الصور، وكالعادة ينجح براون في رسم الصورة من خلال ذاكرته البصرية،
لهذا أقول إن الرواية وجبة دسمة، لكنها غير جاهزة للتناول، فهي أطروحات للأفكار والنظريات، تثير التساؤل والبحث.
في رحلة كيرش للبحث عن إجابة السؤالين المسيطرين على البشرية بخصوص أصلها، يتعرض أيضا للبحث عن سيطرة الأديان على البشرية، وعدائها للعلم، وتأثير رجال الدين على إيمان الناس ومعتقدهم.
«كلما واجه القدماء ثغرة في فهم العالم الذي يحيط بهم كانوا يملأون تلك الثغرات بالآلهة»، هذا الاقتباس يطرحه الكاتب حول فكرة خطيرة وهي ماذا لو أن الدين كان نتاج تسأؤل الإنسان حول ما يدور حوله من ظواهر، وأن الإنسان قد يخترع القصص ويؤلف الحكايات لكي يعطي إجابات لا تقنعه، لكنها علي الأقل تطمئن حالة الخوف والتوتر من المجهول الذي لا يعلم له تفسيراً، أوفي اقتباس آخر يصف الكاتب إنجازات الإنسان أيضا أنها بدافع خوفه فيقول: «قد نختلف أنا وأنت في تعريف الإنسان، لكن ما هو أكيد أنه سيكون الكائن الخائف».
تمثال المامان وخطر الذكاء الاصطناعي
تستعرض الرواية أيضا مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي، فنرى أجهزة حديثة جدا، ومخترعات العالم الشاب كيرش، كسماعات التوصيل العظمي، والمرشد الاصطناعي "وينستون" الذي رافق البروفيسور "لانجدون" في رحلته.
وشخصية "ويبستون" كانت تمثيلا لخطر الذكاء الاصطناعي، فقد شبه الكاتب ذلك الخطر بتمثال الأرملة السوداء - وهي أنثى عنكبوت ضخمة - تحمل كيس بيوض، قد تبدو مخيفة ومفترسة وقاتلة وملتهمة، لكنها من وجه آخر تمنح الحياة، وهنا الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يقف على أرجل ضعيفة هشة، هي الأنظمة الرقمية المعرضة دائما للقرصنة والفيرسة والانهيار، لكنه أيضا رغم هشاشته قادر على حل المشكلات والإجابة عن التساؤلات وإنجاز المهمات، تماما كالأرملة السوداء رغم عطائها ستلتهم البشر في نهاية الامر.
البروفيسور "لانجدون "عالم الرموز
في روايتنا خصوصا، رأيت البروفيسور لانجدون ليس بطلا فحسب، لكنه رمز للمسافة بين الدين والعلم، وفي الأحداث يحاول البروفيسور دائما فك الرموز ووضع التفاسير لنظريات العلم ومعتقدات الدين، فيقرب بينهم تارة ويفض الاشتباك تارة أخرى، فنراه حلقة الوصل بين العالمين.
«العلم والدين ليسا متنافسين، ولكنهما لغتان، ولكل منهما مكانة في هذا العالم»، هذه الفكرة التي طرحها بروان، عن أن العلم والدين لغتان مختلفتان، ولكلٍّ مكانه في عالمنا، تؤصل لفكرة لا تلاقٍ ولا صراعٌ بين العلم والدين، وهذا في الحقيقة يدعونا للتفكر؛ هل الدين لغة والعلم لغة أخرى؟ هل عليَّ أن أختار أيهما أتحدث وأتعلم؟ هل لو تم الجمع بينهم ستحدث المغالطة وعدم الاستفادة؟ هذه الفكرة قد باعدت بين العلم والدين، ومنعت التقاءهما؛ لأننا سنكون مجبورين على الاختيار بأي لغة ستتحدث ألسنتنا، أعتقد أنه بإمكاننا القول إن العلم والدين طريقان متوازيان للوصول إلى الغاية ذاتها، وهي الحقيقة، حتي لو اختلفت منهجيات كل طريق، لكن بإمكاننا أن نعبر الطريقين ونستخدمهما.
أما عن مآخذ الرواية
ـ مساواة كل الأديان في الحديث والمنطق ووجهة النظر نحو العلم وسيطرة ثقافة الكاتب الدينية، جعلتني كقارئة أشعر بعدم الإنصاف وعدم بذل المجهود الكافي للحديث عن باقي الأديان بإسهاب كما أُسهب في الحديث عن المسيحية وعن العلم ونظرياته المختلفة، ولكن هذا لا يأتي بجديد، فعادة كتاب الغرب هي الجهل بالإسلام.
ـ دقة الوصف وطوله قد يدفع القارئ إلى الملل رغم تفرد أسلوب براون الجغـ ـروائي، فالقاريء الحديث ملولٌ، وطول الوصف هنا سلاح ذو حدين.
وفي الأخير، الرواية دسمة تحتاج لقارئٍ صبورٍ لطولها، ودؤوبٍ لكثرة تفاصيلها، وناقدٍ لحساسية أطروحاتها، فقد حدثتنا عن العلم ونظرياته وميلر والتكنولوجيا والحوسبة، وعن نيتشه وفلسفته، وأنجلو وأعماله، فهي مزيج رائع من العلم والأدب والفلسفة، يستحق أن تقيَّم بثلاث نجمات ونصف.
من قارئه في أول طريقها، وتكتب أولى مراجعاتها
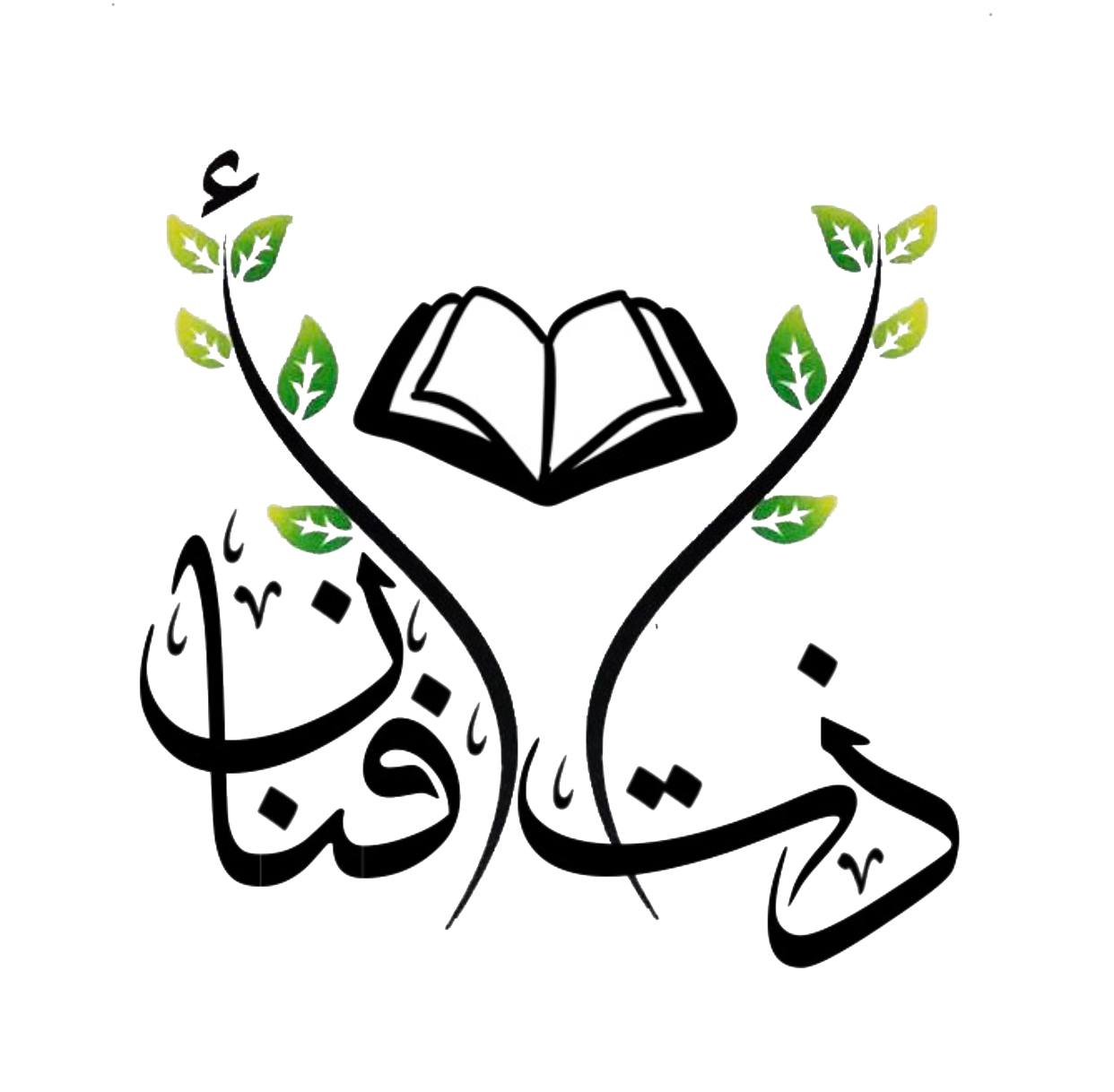



























التعليقات ()